عندما تذكر (قصيدة النثر) يُستحضر على نحوٍ خفي نقيضها المضمر، وكأن في داخل هذا المصطلح ظلاً يهمس بما يقابله (اللا-قصيدة النثر)، غير أن هذا النقيض ليس شيئاً واحداً يمكن تحديده كطرفٍ مقابل، بل هو شبكة من الدلالات التي تتغير بحسب السياق الثقافي والتاريخي والجمالي، ذلك أن السؤال عن (اللا-قصيدة) يقود إلى السؤال عن حدود اللغة نفسها، وعن قدرتها على احتواء ما يتفلت منها، فاللغة حين تُستخدم في الشعر لا تبقى خاضعة لقواعد النحو أو العروض الصارمة، انسجاماً ربما مع المقولة الشهيرة (يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره)، إذ تتحول إلى كيان حي يُعيد تشكيل حدوده من داخل التوتر والرغبة في التجاوز، ومن هنا تنشأ المفارقة فقصيدة النثر جاءت لتتحرر من الأشكال التقليدية، لكنها ما إن تُعرف أو تُسمى حتى تقع من جديد في أسر اللغة نفسها التي كانت تسعى للتحرر منها.
يبدأ الوعي بهذه الإشكالية حين يُفكر في القصيدة لا بوصفها شكلاً أو قالباً، بل باعتبارها حدثاً لغوياً يقع في منطقةٍ بين النثر والشعر، فحين يُقال (قصيدة النثر) فذلك يعني ضمناً أن هناك ما هو خارجها، أي نصوصاً تنتمي إلى نثرٍ لا يحمل التوتر الشعري ولا الإيقاع الداخلي الذي يُعيد ترتيب التجربة في اللغة، لذلك وبهذا المعنى، فـ(اللا-قصيدة النثر) ليست ضداً نوعيا للشعر الموزون وحده، بل كل كتابةٍ تستقر وتتطامن إلى وظيفتها دون أن تقلق شكلها أو معناها، فالنص الذي يطمئن إلى وزنه أو إلى نثره على حد سواء، يفقد عنصر الشعر، لأن الشعر ليس في الوزن ولا في الانعتاق منه، بل في المسافة التي يخلقها النص بين القول ومعناه، وبين اللغة وذاتها.
ينبغي القول إنّ قصيدة النثر وُلدت من رحم المفارقة، إذ أنها لم ترفض الوزن لتقيم نثراً خالصاً، بل لتعيد للشعر جوهره المفقود، ولأن الشعر في الأصل موقف من الوجود قبل أن يكون صناعة لغوية، فإن (اللا-قصيدة النثر) هي كل كتابةٍ تنقطع عن هذا الموقف، وتستخدم اللغة بوصفها أداة تواصل فقط، لا بوصفها (بيتاً للكينونة) كما يصفها هايدغر، فحين يتحول الشعر إلى حرفة أو إلى تكرارٍ للأنماط، يصبح أقرب إلى النثر الخالص، بينما حين يتحول إلى طاقةٍ (روحية) استكشافية، إن جاز لي الوصف، تفتش عن المعنى في أقصى حدوده، يصبح النثر هنا شعراً خالصاً.
يُلاحظ أن أغلب شعراء ومنظري قصيدة النثر العربية، منذ أنسي الحاج وأدونيس وخالدة سعيد مروراً بسركون بولص وصلاح فائق، إلى زمننا الحاضر، لم يكونوا مشغولين بمحو الوزن فقط، بل بمساءلة فكرة الشكل نفسها، فأنسي الحاج، مثلاً، وفي مقدمة ديوانه (لن)، لم يكتب بياناً ضد العمود، بل كتب بياناً ضد الخضوع لأي شكلٍ مغلق، إذ يحاول أن يؤسس لقصيدة النثر بوصفها فعلاً تحررياً وجودياً وفنياً، يرفض الأطر الشكلية واللغوية الموروثة ليعيد تعريف الشعر باعتباره طاقة خلقٍ مطلقة تنبع من حرية الشاعر الداخلية لا من القوانين الخارجية للشكل والوزن، حيث يتساءل ويجيب (هل يمكن أن نخرج من النثر قصيدة؟ أجل، فالنظم ليس هو الفرق الحقيقي بين النثر والشعر. لقد قدمت جميع التراثات الحية شعراً عظيماً في النثر، ولا تزال. وما دام الشعر لا يعرف بالوزن والقافية، فليس ما يمنع أن يتألف من النثر شعر، ومن شعر النثر قصيدة نثر.)، لذلك يمكن القول إن (اللا-قصيدة) هنا ليست قصيدة البحر الطويل أو الكامل أو المتقارب، بل هي القصيدة التي تستسلم لزخرفها، أي التي تكتفي بأن تكون (قصيدة) بمعناها المتداول دون أن تجرب أن تكون رؤيا، أما أدونيس فقد رأى أن الشعر الحقيقي هو ما يعبر عن وعيٍ جديد باللغة، لأن اللغة القديمة لم تعد تقدر على حمل تحوّل الإنسان، حيث تصبح (اللا-قصيدة) هي كل كتابةٍ تتكلم بلغةٍ ميتة أو بوعيٍ مغلق، مهما كانت جميلة في ظاهرها.
حين نقرأ تجربة بودلير أو رامبو أو غيرهما، يتضح أن قصيدة النثر لم تكن محاولة لتبديل الموسيقى الخارجية بموسيقى أخرى فقط، بل لتبديل العلاقة بين الذات والعالم، بين المعنى والوجودـ، لذلك يصبح من التعسف أن يُختزل نقيضها بالوزن وحده، لأن (اللا-قصيدة النثر)، هي ربما غياب الرؤية، وغياب المغامرة، وغياب التوتر الذي يجعل اللغة تولد من جديد في كل نص، يمكن القول إن كل نصٍ يكتب اللغة كأنها شيء مفروغ منه، لا كأنها مغامرة وجود، هو نص يقع في منطقة (اللا-قصيدة،) سواء أكان موزوناً أم منثوراً.
يتّضح لنا إذأ أن قصيدة النثر ليست نقيض الوزن بل نقيض الاطمئنان، وأنّ (اللا-قصيدة النثر)، ليست الشكل الآخر بل الروح المنطفئة، فالنص الذي لا يغامر باللغة ولا يوسع أفقها هو نثر في المعنى العميق للكلمة، حتى وإن كان موزوناً، أما النص الذي يخلق لنفسه إيقاعاً داخلياً، ويحافظ على التوتر بين التجربة واللغة، فهو الشعر، ولو كتب نثراً. بذلك يمكن القول إن الشعر لا يقيم في الوزن ولا في النثر، بل في الموقف من اللغة، وهذا ما يجعل قصيدة النثر امتحاناً مستمراً للشعر نفسه، لأنها تجبره على أن يبرر وجوده خارج الأشكال التي طالما احتمى بها.
حين يُعاد النظر في المصطلح من هذه الزاوية، يُكتشف أن التسمية ذاتها (قصيدة النثر) ليست إلا محاولة لتسمية ما لا يُسمى، أي لإيجاد مكان للغة حين تُصبح بلا جدران، فـ(اللا-قصيدة النثر)، في النهاية، هي اللغة حين تُغلق نوافذها، وحين تتحول من كائنٍ حي إلى أثرٍ لغوي جامد، أما قصيدة النثر، فهي اللغة حين تستعيد طفولتها الأولى، وحين تتكلم لا لتُخبر، بل لتُفكر، لا لتُقنع، بل لتكتشف، وبين هذين الحدّين، يتحدد مصير الشعر كله.
مقالات أخرى للكاتب
لا توجد مقالات أخرى لهذا الكاتب.
اللا-قصيدة النثر بحثٌ في حدود الشعر ومفارقات اللغة
عندما تذكر (قصيدة النثر) يُستحضر على نحوٍ خفي نقيضها المضمر، وكأن في داخل هذا المصطلح ظلاً يهمس بما يقابله (اللا-قصيدة النثر)، غير أن هذا النقيض ليس شيئاً واحداً يمكن تحديده كطرفٍ مقابل، بل هو شبكة من الدلالات التي تتغير بحسب السياق الثقافي والتاريخي والجمالي، ذلك أن السؤال عن (اللا-قصيدة) يقود إلى السؤال عن حدود اللغة نفسها، وعن قدرتها على احتواء ما يتفلت منها، فاللغة حين تُستخدم في الشعر لا تبقى خاضعة لقواعد النحو أو العروض الصارمة، انسجاماً ربما مع المقولة الشهيرة (يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره)، إذ تتحول إلى كيان حي يُعيد تشكيل حدوده من داخل التوتر والرغبة في التجاوز، ومن هنا تنشأ المفارقة فقصيدة النثر جاءت لتتحرر من الأشكال التقليدية، لكنها ما إن تُعرف أو تُسمى حتى تقع من جديد في أسر اللغة نفسها التي كانت تسعى للتحرر منها.
يبدأ الوعي بهذه الإشكالية حين يُفكر في القصيدة لا بوصفها شكلاً أو قالباً، بل باعتبارها حدثاً لغوياً يقع في منطقةٍ بين النثر والشعر، فحين يُقال (قصيدة النثر) فذلك يعني ضمناً أن هناك ما هو خارجها، أي نصوصاً تنتمي إلى نثرٍ لا يحمل التوتر الشعري ولا الإيقاع الداخلي الذي يُعيد ترتيب التجربة في اللغة، لذلك وبهذا المعنى، فـ(اللا-قصيدة النثر) ليست ضداً نوعيا للشعر الموزون وحده، بل كل كتابةٍ تستقر وتتطامن إلى وظيفتها دون أن تقلق شكلها أو معناها، فالنص الذي يطمئن إلى وزنه أو إلى نثره على حد سواء، يفقد عنصر الشعر، لأن الشعر ليس في الوزن ولا في الانعتاق منه، بل في المسافة التي يخلقها النص بين القول ومعناه، وبين اللغة وذاتها.
ينبغي القول إنّ قصيدة النثر وُلدت من رحم المفارقة، إذ أنها لم ترفض الوزن لتقيم نثراً خالصاً، بل لتعيد للشعر جوهره المفقود، ولأن الشعر في الأصل موقف من الوجود قبل أن يكون صناعة لغوية، فإن (اللا-قصيدة النثر) هي كل كتابةٍ تنقطع عن هذا الموقف، وتستخدم اللغة بوصفها أداة تواصل فقط، لا بوصفها (بيتاً للكينونة) كما يصفها هايدغر، فحين يتحول الشعر إلى حرفة أو إلى تكرارٍ للأنماط، يصبح أقرب إلى النثر الخالص، بينما حين يتحول إلى طاقةٍ (روحية) استكشافية، إن جاز لي الوصف، تفتش عن المعنى في أقصى حدوده، يصبح النثر هنا شعراً خالصاً.
يُلاحظ أن أغلب شعراء ومنظري قصيدة النثر العربية، منذ أنسي الحاج وأدونيس وخالدة سعيد مروراً بسركون بولص وصلاح فائق، إلى زمننا الحاضر، لم يكونوا مشغولين بمحو الوزن فقط، بل بمساءلة فكرة الشكل نفسها، فأنسي الحاج، مثلاً، وفي مقدمة ديوانه (لن)، لم يكتب بياناً ضد العمود، بل كتب بياناً ضد الخضوع لأي شكلٍ مغلق، إذ يحاول أن يؤسس لقصيدة النثر بوصفها فعلاً تحررياً وجودياً وفنياً، يرفض الأطر الشكلية واللغوية الموروثة ليعيد تعريف الشعر باعتباره طاقة خلقٍ مطلقة تنبع من حرية الشاعر الداخلية لا من القوانين الخارجية للشكل والوزن، حيث يتساءل ويجيب (هل يمكن أن نخرج من النثر قصيدة؟ أجل، فالنظم ليس هو الفرق الحقيقي بين النثر والشعر. لقد قدمت جميع التراثات الحية شعراً عظيماً في النثر، ولا تزال. وما دام الشعر لا يعرف بالوزن والقافية، فليس ما يمنع أن يتألف من النثر شعر، ومن شعر النثر قصيدة نثر.)، لذلك يمكن القول إن (اللا-قصيدة) هنا ليست قصيدة البحر الطويل أو الكامل أو المتقارب، بل هي القصيدة التي تستسلم لزخرفها، أي التي تكتفي بأن تكون (قصيدة) بمعناها المتداول دون أن تجرب أن تكون رؤيا، أما أدونيس فقد رأى أن الشعر الحقيقي هو ما يعبر عن وعيٍ جديد باللغة، لأن اللغة القديمة لم تعد تقدر على حمل تحوّل الإنسان، حيث تصبح (اللا-قصيدة) هي كل كتابةٍ تتكلم بلغةٍ ميتة أو بوعيٍ مغلق، مهما كانت جميلة في ظاهرها.
حين نقرأ تجربة بودلير أو رامبو أو غيرهما، يتضح أن قصيدة النثر لم تكن محاولة لتبديل الموسيقى الخارجية بموسيقى أخرى فقط، بل لتبديل العلاقة بين الذات والعالم، بين المعنى والوجودـ، لذلك يصبح من التعسف أن يُختزل نقيضها بالوزن وحده، لأن (اللا-قصيدة النثر)، هي ربما غياب الرؤية، وغياب المغامرة، وغياب التوتر الذي يجعل اللغة تولد من جديد في كل نص، يمكن القول إن كل نصٍ يكتب اللغة كأنها شيء مفروغ منه، لا كأنها مغامرة وجود، هو نص يقع في منطقة (اللا-قصيدة،) سواء أكان موزوناً أم منثوراً.
يتّضح لنا إذأ أن قصيدة النثر ليست نقيض الوزن بل نقيض الاطمئنان، وأنّ (اللا-قصيدة النثر)، ليست الشكل الآخر بل الروح المنطفئة، فالنص الذي لا يغامر باللغة ولا يوسع أفقها هو نثر في المعنى العميق للكلمة، حتى وإن كان موزوناً، أما النص الذي يخلق لنفسه إيقاعاً داخلياً، ويحافظ على التوتر بين التجربة واللغة، فهو الشعر، ولو كتب نثراً. بذلك يمكن القول إن الشعر لا يقيم في الوزن ولا في النثر، بل في الموقف من اللغة، وهذا ما يجعل قصيدة النثر امتحاناً مستمراً للشعر نفسه، لأنها تجبره على أن يبرر وجوده خارج الأشكال التي طالما احتمى بها.
حين يُعاد النظر في المصطلح من هذه الزاوية، يُكتشف أن التسمية ذاتها (قصيدة النثر) ليست إلا محاولة لتسمية ما لا يُسمى، أي لإيجاد مكان للغة حين تُصبح بلا جدران، فـ(اللا-قصيدة النثر)، في النهاية، هي اللغة حين تُغلق نوافذها، وحين تتحول من كائنٍ حي إلى أثرٍ لغوي جامد، أما قصيدة النثر، فهي اللغة حين تستعيد طفولتها الأولى، وحين تتكلم لا لتُخبر، بل لتُفكر، لا لتُقنع، بل لتكتشف، وبين هذين الحدّين، يتحدد مصير الشعر كله.




 فرح تركي العامري
فرح تركي العامري 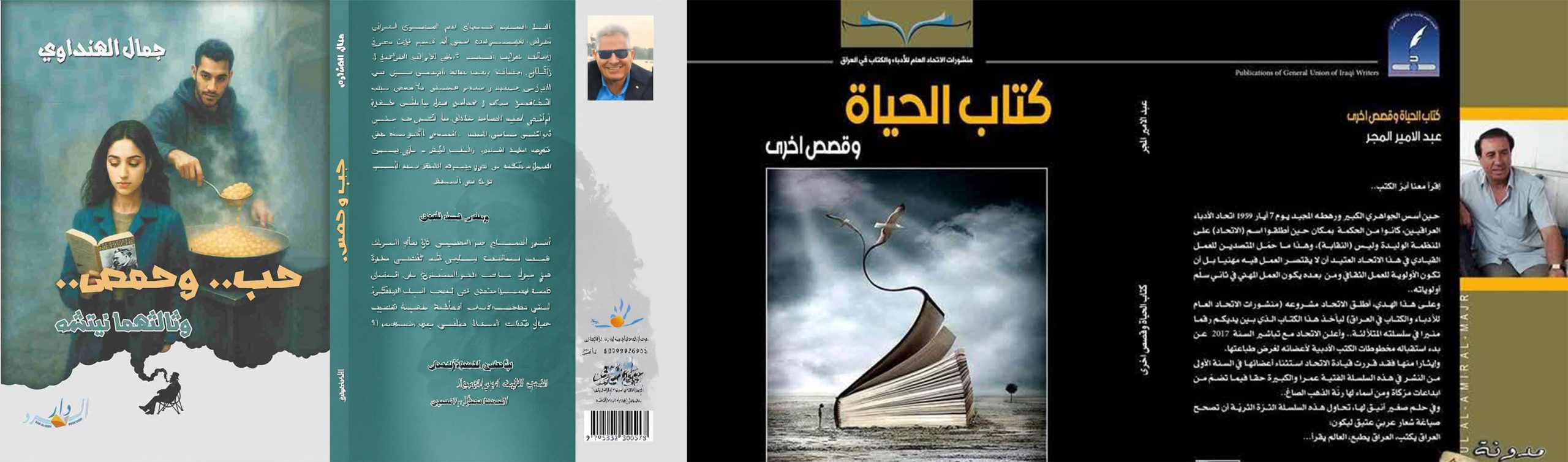
 حیدر الأدیب
حیدر الأدیب 
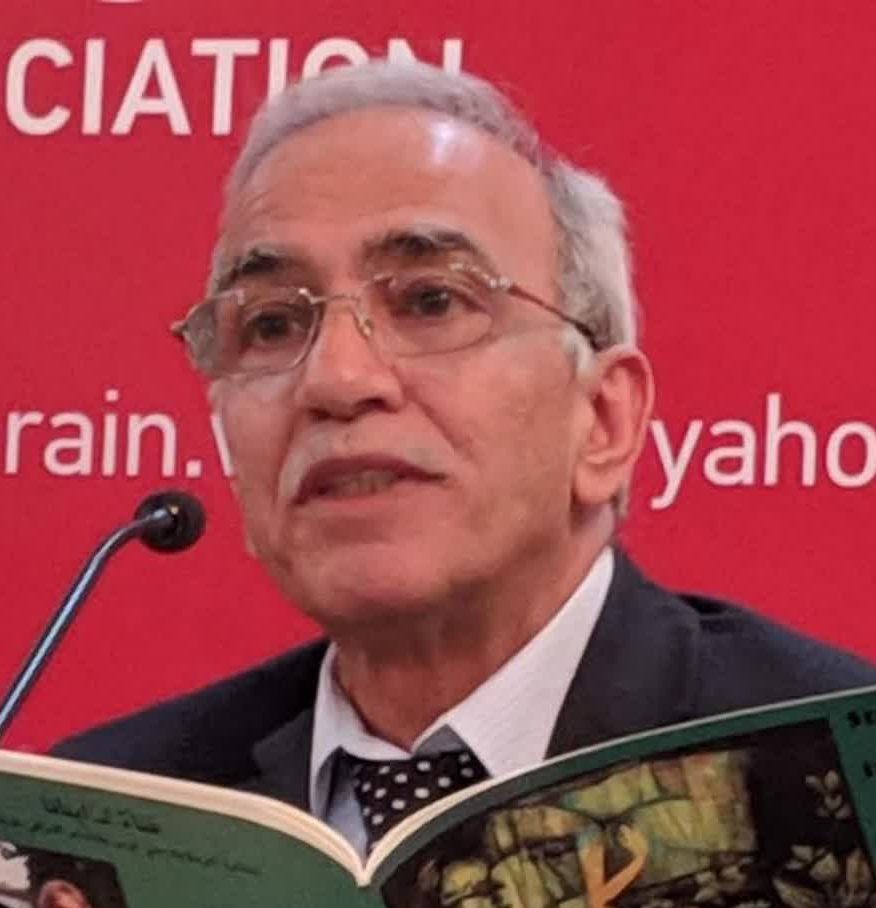 عدنان الصائغ
عدنان الصائغ 



التعليقات