(كوثر علي، تعالي إلى السبورة).
هكذا كُسِرَ سكونُ أفكاري، واقتحمه صوتٌ بوحشية. قمتُ من مقعدي واتجهتُ نحو السبورة بخطواتٍ ثقيلةٍ جدًا. وقفتُ أمام سبورةٍ مثقلة بكتابات الطباشير حتى التُّخمة، وبدأتُ بتنظيفها بعنايةٍ ولطف، بالإسفنجة التي كانت تستغيث في قبضتي، إذ بلغت حدَّ التقيؤ والاشمئزاز من ابتلاع الطباشير. كنتُ أمسح السبورة وأرى ذرات الطباشير تحاول أن تُبقي أثرها على ملابسي ووجهي. وكانت معلمتي تكسر باستمرار لحظات سكوني بصوتها المزعج، وإلحاحها على الإسراع في التنظيف كان أكثر إزعاجًا. أكملتُ تنظيف السبورة، ثم دُرتُ أبحث عن قطعة طباشير لأبدأ بكتابة السؤال، لكنني لم أجد. يا لحسن حظي! نظرتُ إلى عقارب ساعة الصف: بقي ربع ساعة حتى تنتهي معاناتي على السبورة. لا بأس ببعض المماطلة وضياع الوقت لأتجنب حلَّ السؤال أمام العيون. صحيح أنني أعترف بذكائي وحبّي لحلّ الألغاز وأسئلة الرياضيات والفيزياء، لكنني لا أحب سطوة الأعين عليَّ، ولا ضغط التقييم، ولا مطاردتي بعقارب الساعة. أنا لا أحب الركض تحت الضغط. العالم كلّه يركض تحت الضغط، أمّا أنا فأحب أن أركض بجناحيّ. قلتُ لمعلمتي: لا توجد طباشير، هل تسمحين لي بإحضارها من مكتب المديرة؟ فقالت: تمام، لكن لا تتأخري. في لحظة سماع جوابها، ارتسمت على وجهي ابتسامة شريرة لا تُمحى. فتحتُ الباب واتجهتُ إلى مكتب المديرة، ولكن لسوء حظي كان المكتب ملاصقًا لصفّي. حاولتُ بكل وسيلة أن أبطئ حركاتي، لكن العملية انتهت بسرعة، ولا أعرف كيف. رجعتُ ووقفتُ مرة أخرى أمام السبورة وبدأتُ بكتابة السؤال. كان سؤالًا جميلاً، ومع ذلك ظلَّ التوتر يسري في أوصالي. لم يكن عقلي متوترًا، بل أنا. كان يجب أن أكتب الحلَّ بأسرع وأحسن طريقة، وبدون خطأ، أمرٌ يُشبه خضوعك لمعركةٍ يجب أن تفوز بها لتحافظ على عرشك كأفضل تلميذة في الصف. ورغم معاناتي، كان عقلي في عالم آخر؛ إذ رفع بنطاله حتى وصل إلى قفصه الصدري، وعدّل نظارته، وجهّز نفسه لاستكشاف جديد. لماذا دائمًا أمام السبورة أسمع ضجيجًا كثيرًا؟ حتى أنفاس الطلاب في المقاعد الأخيرة صارت قابلة للسمع. أمّا أصوات ضحكات الأطفال ولعبهم في محيط المدرسة، فهي ما كنتُ أسمعها، وقد خطف ذلك قلبي بالفعل. كنتُ أرى قلبي واقفًا على حافة نافذة الصف، يتابع تحركات الكرة بكل ولع، كقطةٍ تلاحق كرتها الصوفية، وعلى وجهها ابتسامة عريضة. يا لقلبي الساذج الطفولي! كنتُ أفكر كيف أعيده إلى مكانه، حتى رنّ الجرس وانتهى كل شيء. عاد قلبي وعقلي متخاذلين: عقلي لم يُكمل لُغزه، وقلبي لم يشبع من عرض الكرة ولعب الأطفال. أمّا أنا، فقد شعرتُ براحة، خصوصًا بعد سماع معلمتي تقول: “لا بأس كوثر، نكملها غدًا إن شاء الله.” لكن لماذا شعرتُ بالراحة؟ لا أدري. ربما لأن عقلي وقلبي اجتمعا مرة أخرى بداخلي رغمًا عنهما. خرجتُ من المدرسة أركض بسرعة، وكانت وجوه الطلاب والمدرّسات، وحتى تفاصيل المدرسة، تتلاشى أمام عيني بسرعة فائقة. حملتُ حقيبتي على ظهري وبدأتُ أسلك الطريق نحو بيتنا. شارع طويل ومزدحم ببشرٍ يتعثرون بك بين حينٍ وآخر. كلّهم متشابهون: رجال ونساء، أجسادهم تشبه خريطة “بازل” غير مكتملة، كلٌّ منهم يفتقد قطعة أو أكثر. أراهم مثقلين، وتستطيع أن تتخيل هذا بسهولة: كلٌّ يسير بثقلٍ عالٍ كأنما يحمل على ظهره أشياء كثيرة لا تُرى، أشياء أثقل من حقيبتي المدرسية على ظهري. وفوق رؤوسهم يطير سرب عصافير، لكن لا يُغرّد، بل ينقل الأخبار بين الواقع والخيال بطريقة مزعجة. كم تمنيت أن أكون قادرة على كشف القطع المفقودة فيهم. أحيانًا بدافع الفضول أحاول أن أختلس النظر داخل أماكن القطع المفقودة، لكنني لا أرى شيئًا سوى حفرة سوداء تنتظر قطعةً لتكملها. أنظر إلى وجوههم فلا تعبّر عن شيء. كنتُ أتمنى أن أرى ما يشعرون به أو يفكرون به في دواخلهم. رغم ذلك، أحيانًا أرى ابتساماتهم حين تلتصق على وجوههم أوراق حبٍّ تحملها الريح. يبعدونها عن وجوههم، يقرؤونها بدقة، يضحكون، ثم يرمونها ويكملون طريقهم. ورغم أنني لا أفهم سبب ضحكاتهم، إلا أن الأمر يعجبني كثيرًا. أمّا أنا، فكم مرة حملتني الريح أوراقًا، فقرأتها بدقة بالغة، لكنها بدت ككذبة رخيصة جدًا، لا تشبه ما قرأتُ في كتب الأدب. ومع أنني أعتقد أن ما قرأتُه في كتب الأدب أيضًا كذبة، لكنها كذبة أسطورية أكثر جمالًا. أما أنا، فأُفضّل أن أرى مشهد ملكة ترقص على مائدة طعام مليئة برؤوس ضحاياها، وباطن قدميها مصبوغٌ بلون دمائهم الأحمر، وتغنّي للفراغ، بينما وجوه ضحاياها مرسومة بابتسامة عريضة ويهتفون لها في كل سَكْر، ويكملون مسرحًا موسيقيًا فاخرًا. لكن ما أراه في تلك الأوراق ليس سوى كتابةٍ لمشهد عن عنكبوت وحشرات ولا يُضحكني أبدًا. على أي حال، واصلتُ طريقي نحو البيت وأنا أفكر في مدينتي الرمادية، بأزقتها السوداء، وأشجارها الخضراء، وشوارعها المليئة بمرايا غير مصقولة تعكس وجهي وجسدي مشوَّهين بأشكال مختلفة.
نسيتُ أن أذكر الفصول التي تمرُّ بها مدينتي: فهنا، كل مكان يحمل فصلًا من فصول السنة. المقبرة يسكنها الربيع والشتاء، أمّا الحدائق والأشجار فيسكنها الصيف، وأمّا البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات فيسكنها خريف جميل. أمّا المساجد والصوامع والكنائس، فيسكنها فصل القيامة؛ نعم فصل القيامة ولا تدري من يقيم هذا الفصل في داخلها، أهو الله أم الشيطان. أمّا المقرّ الطبقة المخملية في مدينتي فلا يعرف فصلًا؛ كلما رأيته ذكّرني بقصور الأشرار في الرسوم الكرتونية: مبنى مخيف بلون أزرق مسوَّد، يعلوه غيمٌ أسود، ورعدٌ يضرب برجه باستمرار. في داخله تسكن المهرّج قصيرة القامة، مضحكة ولا تحمل من ذكاء شيء، تحمل بندقية وتفتش عن شيء لتدمّره. ونسيتُ أن أقول عن النهر الذي يجري على جهتي اليسرى تمامًا. يعجبني جدًّا، وتمنيتُ أن أسبح فيه يومًا وأشعر بمائه. لكن لماذا “يومًا ما”؟ فقررتُ أن أُغامر، فاتجهتُ نحوه رغم قرب وصولي إلى البيت. خلعتُ حذائي وقفزتُ فوق الحاجز، واتجهتُ نحو النهر. اسمه “منطق”. كم شعرتُ أن قدميَّ عطشانتان لتجربة مائه! بدأتُ أمشي على حجارة “ا
السبورة والنهر (كوثر علي، تعالي إلى السبورة). هكذا كُسِرَ سكونُ أفكاري، واقتحمه صوتٌ بوحشية. قمتُ من مقعدي واتجهتُ نحو السبورة بخطواتٍ ثقيلةٍ جدًا. وقفتُ أمام سبورةٍ مثقلة بكتابات الطباشير حتى التُّخمة، وبدأتُ بتنظيفها بعنايةٍ ولطف، بالإسفنجة التي كانت تستغيث في قبضتي، إذ بلغت حدَّ التقيؤ والاشمئزاز من ابتلاع الطباشير. كنتُ أمسح السبورة وأرى ذرات الطباشير تحاول أن تُبقي أثرها على ملابسي ووجهي. وكانت معلمتي تكسر باستمرار لحظات سكوني بصوتها المزعج، وإلحاحها على الإسراع في التنظيف كان أكثر إزعاجًا. أكملتُ تنظيف السبورة، ثم دُرتُ أبحث عن قطعة طباشير لأبدأ بكتابة السؤال، لكنني لم أجد. يا لحسن حظي! نظرتُ إلى عقارب ساعة الصف: بقي ربع ساعة حتى تنتهي معاناتي على السبورة. لا بأس ببعض المماطلة وضياع الوقت لأتجنب حلَّ السؤال أمام العيون. صحيح أنني أعترف بذكائي وحبّي لحلّ الألغاز وأسئلة الرياضيات والفيزياء، لكنني لا أحب سطوة الأعين عليَّ، ولا ضغط التقييم، ولا مطاردتي بعقارب الساعة. أنا لا أحب الركض تحت الضغط. العالم كلّه يركض تحت الضغط، أمّا أنا فأحب أن أركض بجناحيّ. قلتُ لمعلمتي: لا توجد طباشير، هل تسمحين لي بإحضارها من مكتب المديرة؟ فقالت: تمام، لكن لا تتأخري. في لحظة سماع جوابها، ارتسمت على وجهي ابتسامة شريرة لا تُمحى. فتحتُ الباب واتجهتُ إلى مكتب المديرة، ولكن لسوء حظي كان المكتب ملاصقًا لصفّي. حاولتُ بكل وسيلة أن أبطئ حركاتي، لكن العملية انتهت بسرعة، ولا أعرف كيف. رجعتُ ووقفتُ مرة أخرى أمام السبورة وبدأتُ بكتابة السؤال. كان سؤالًا جميلاً، ومع ذلك ظلَّ التوتر يسري في أوصالي. لم يكن عقلي متوترًا، بل أنا. كان يجب أن أكتب الحلَّ بأسرع وأحسن طريقة، وبدون خطأ، أمرٌ يُشبه خضوعك لمعركةٍ يجب أن تفوز بها لتحافظ على عرشك كأفضل تلميذة في الصف. ورغم معاناتي، كان عقلي في عالم آخر؛ إذ رفع بنطاله حتى وصل إلى قفصه الصدري، وعدّل نظارته، وجهّز نفسه لاستكشاف جديد. لماذا دائمًا أمام السبورة أسمع ضجيجًا كثيرًا؟ حتى أنفاس الطلاب في المقاعد الأخيرة صارت قابلة للسمع. أمّا أصوات ضحكات الأطفال ولعبهم في محيط المدرسة، فهي ما كنتُ أسمعها، وقد خطف ذلك قلبي بالفعل. كنتُ أرى قلبي واقفًا على حافة نافذة الصف، يتابع تحركات الكرة بكل ولع، كقطةٍ تلاحق كرتها الصوفية، وعلى وجهها ابتسامة عريضة. يا لقلبي الساذج الطفولي! كنتُ أفكر كيف أعيده إلى مكانه، حتى رنّ الجرس وانتهى كل شيء. عاد قلبي وعقلي متخاذلين: عقلي لم يُكمل لُغزه، وقلبي لم يشبع من عرض الكرة ولعب الأطفال. أمّا أنا، فقد شعرتُ براحة، خصوصًا بعد سماع معلمتي تقول: “لا بأس كوثر، نكملها غدًا إن شاء الله.” لكن لماذا شعرتُ بالراحة؟ لا أدري. ربما لأن عقلي وقلبي اجتمعا مرة أخرى بداخلي رغمًا عنهما. خرجتُ من المدرسة أركض بسرعة، وكانت وجوه الطلاب والمدرّسات، وحتى تفاصيل المدرسة، تتلاشى أمام عيني بسرعة فائقة. حملتُ حقيبتي على ظهري وبدأتُ أسلك الطريق نحو بيتنا. شارع طويل ومزدحم ببشرٍ يتعثرون بك بين حينٍ وآخر. كلّهم متشابهون: رجال ونساء، أجسادهم تشبه خريطة “بازل” غير مكتملة، كلٌّ منهم يفتقد قطعة أو أكثر. أراهم مثقلين، وتستطيع أن تتخيل هذا بسهولة: كلٌّ يسير بثقلٍ عالٍ كأنما يحمل على ظهره أشياء كثيرة لا تُرى، أشياء أثقل من حقيبتي المدرسية على ظهري. وفوق رؤوسهم يطير سرب عصافير، لكن لا يُغرّد، بل ينقل الأخبار بين الواقع والخيال بطريقة مزعجة. كم تمنيت أن أكون قادرة على كشف القطع المفقودة فيهم. أحيانًا بدافع الفضول أحاول أن أختلس النظر داخل أماكن القطع المفقودة، لكنني لا أرى شيئًا سوى حفرة سوداء تنتظر قطعةً لتكملها. أنظر إلى وجوههم فلا تعبّر عن شيء. كنتُ أتمنى أن أرى ما يشعرون به أو يفكرون به في دواخلهم. رغم ذلك، أحيانًا أرى ابتساماتهم حين تلتصق على وجوههم أوراق حبٍّ تحملها الريح. يبعدونها عن وجوههم، يقرؤونها بدقة، يضحكون، ثم يرمونها ويكملون طريقهم. ورغم أنني لا أفهم سبب ضحكاتهم، إلا أن الأمر يعجبني كثيرًا. أمّا أنا، فكم مرة حملتني الريح أوراقًا، فقرأتها بدقة بالغة، لكنها بدت ككذبة رخيصة جدًا، لا تشبه ما قرأتُ في كتب الأدب. ومع أنني أعتقد أن ما قرأتُه في كتب الأدب أيضًا كذبة، لكنها كذبة أسطورية أكثر جمالًا. أما أنا، فأُفضّل أن أرى مشهد ملكة ترقص على مائدة طعام مليئة برؤوس ضحاياها، وباطن قدميها مصبوغٌ بلون دمائهم الأحمر، وتغنّي للفراغ، بينما وجوه ضحاياها مرسومة بابتسامة عريضة ويهتفون لها في كل سَكْر، ويكملون مسرحًا موسيقيًا فاخرًا. لكن ما أراه في تلك الأوراق ليس سوى كتابةٍ لمشهد عن عنكبوت وحشرات ولا يُضحكني أبدًا. على أي حال، واصلتُ طريقي نحو البيت وأنا أفكر في مدينتي الرمادية، بأزقتها السوداء، وأشجارها الخضراء، وشوارعها المليئة بمرايا غير مصقولة تعكس وجهي وجسدي مشوَّهين بأشكال مختلفة.
مقالات أخرى للكاتب
لا توجد مقالات أخرى لهذا الكاتب.




 عبد الأمیر المجر
عبد الأمیر المجر 
 حسن العکیلي
حسن العکیلي 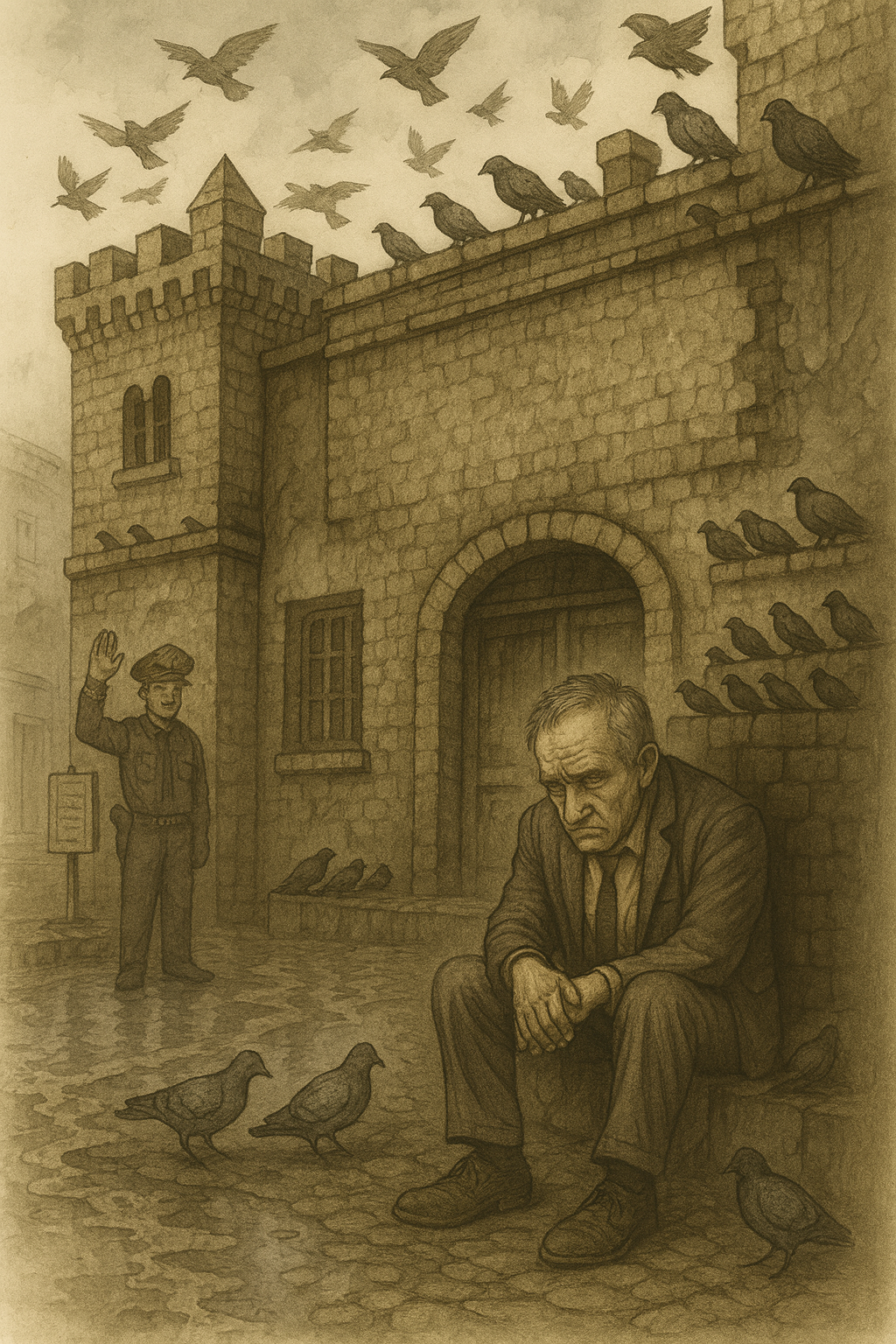
 هادي المیاح
هادي المیاح 




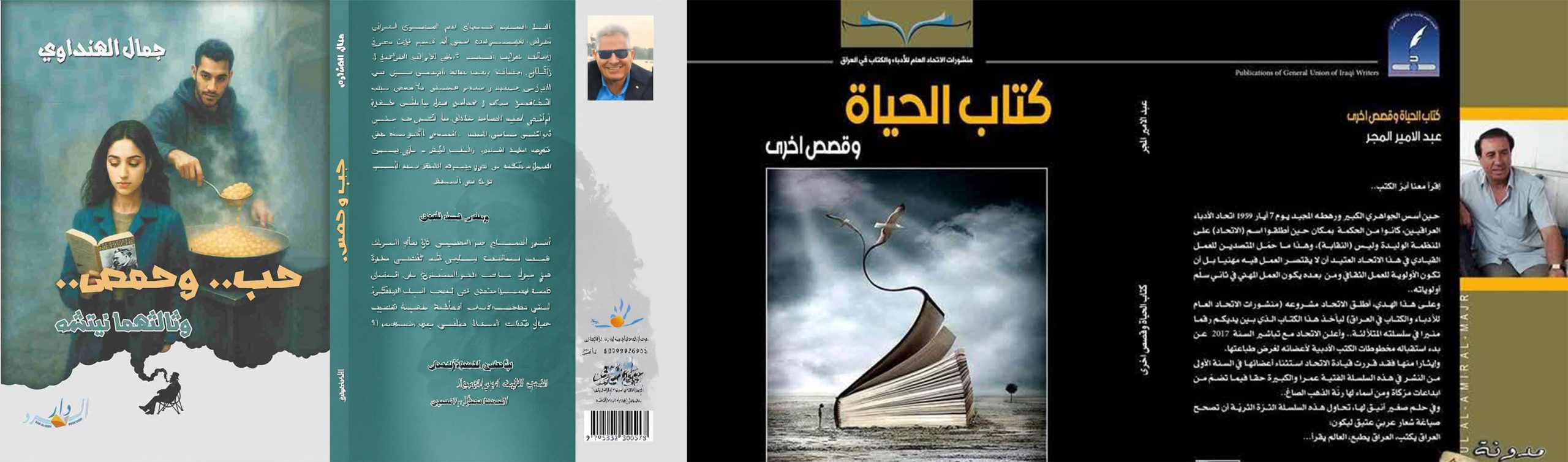
التعليقات